بعد زيارة الشيباني.. السجناء اللبنانيون: دولتنا تخلَّت عنّا؟
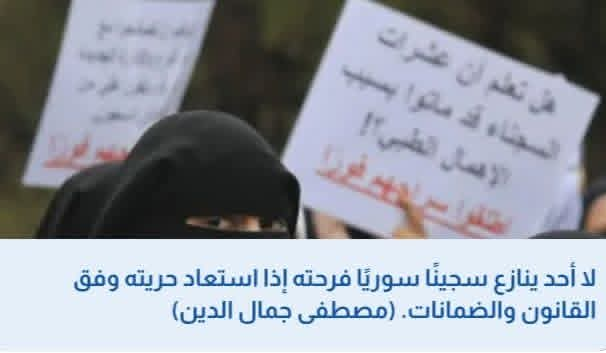
اعتصام أهالي السجناء في سجن رومية المركزي(مصطفى جمال الدين)لا أحد ينازع سجينًا سوريًا فرحته إذا استعاد حريته وفق القانون والضمانات. (مصطفى جمال الدين)
في الأيام القليلة الماضية، عاد ملفّ السجون في لبنان إلى الواجهة على وقع زيارة وزير الخارجيّة السّوريّ أسعد الشيباني إلى بيروت، وما تبعها من حديثٍ سياسيٍّ وقضائيٍّ عن ترتيباتٍ تخصّ الموقوفين السّوريّين في روميّة وسواها. ولكن، خلف هذا الضجيج، تتشكّل حالة سخطٍ متصاعدة بين السجناء اللبنانيّين والفلسطينيّين، الذين يرون في الحراك الجاري معالجةً انتقائيّةً تهمل أوضاعهم المتردّية، وتؤبّد شعورهم بأنّهم "سجناء من الدرجة العاشرة" في وطنهم.
"العلاقة النديّة".. تفاؤلٌ سياسيٌّ يصطدم بجدران روميّة
بعد سقوط نظام الأسد وقيام السّلطة الحالية، طغى في توصيف أحوال لبنان وسوريا، الشقيقين اللدودين، اصطلاحٌ جديد هو "العلاقة النديّة". غير أنّ هذا التعبير ينطوي على قدرٍ وافرٍ من التفاؤل والمثاليّة؛ فهو يوحي بأنّ علاقةً لطالما حكمها الشقاق والنظرة الفوقيّة، وتبادل العذابات والمظلوميّات، بل والانتهاكات الدمويّة، قد بلغت أخيرًا طورًا "ناضجًا سياسيًّا" يقوم على مسارٍ من التفاهم وحوارٍ جدّي، وهو أمرٌ نادرٌ في مشرقنا اليوم. في هذا السّياق، جاءت زيارة وزير الخارجيّة السّوريّ أسعد الشيباني إلى بيروت كأنّها تتويجٌ لتلك الآمال، زيارةٌ أرجئت مرارًا لأسبابٍ مفهومة، وأخرى متّصلة بتوتّراتٍ معلنةٍ وأخرى مكتومة في علاقةٍ لا تزال ضبابيّةً بين البلدين. ومع ذلك، وقعت الزيارة مثقلةً بملفّاتٍ شديدة الخصوصيّة والحساسيّة للطرفين؛ إذ أعقبت تسريباتٍ قبل أشهر عن "سخطٍ ووعيد" سوريّين بالتصعيد إذا لم يُفرج عن المعتقلين السوريّين، وجاءت على مسافة أيّامٍ من تسليم فضل شاكر نفسه، وفي ظلّ ارتباكٍ داخليٍّ لبنانيٍّ واضح.
في الظاهر، بدا المشهد كأنه خطوة إلى الأمام. أمّا داخل السجون، فكان وقعُه مختلفًا.. فوفق ما رشح، انتهت اللقاءات إلى تفاهمٍ، على أن يزور وفدٌ قضائيٌّ سوريٌّ بيروت برئاسة وزير العدل مظهر الويس، لاستكمال البحث في ملفّ الموقوفين وتسريع إطلاق سراح عددٍ منهم، (راجع "المدن"). على هذه الأرضيّة السياسيّة الملتبسة، ارتفع منسوب التوتّر في روميّة. سجناء لبنانيّون يلوّحون بإضرابٍ واسعٍ احتجاجًا على ما يعتبرونه "معاملةً متناقضة" من الحكومة اللبنانيّة: حلٌّ قريبٌ لملفات السوريّين، مقابل استمرار تعثّر ملفات اللبنانيّين والفلسطينيّين بلا أفق. هكذا خرج ملفّ السجون من القاعات المكيّفة إلى الزنازين الرطبة، وصار سؤال العدالة الانتقاليّة هو السّؤال الإشكاليّ.
"صرنا سجناء من الدرجة العاشرة": شهادةٌ من الداخل
ينقل أحد سجناء روميّة في حديثه إلى "المدن" خلاصةً لواقعهم: "لسجناء روميّة السوريّين الحقّ في أن يفرحوا بقرب نيل حريّتهم، غير أنّ شعور زملائهم اللبنانيّين والفلسطينيّين مركّب: نحن سعداء لأجلهم، لكنّنا في الوقت نفسه نعتصر خذلانًا عميقًا. نشعر بأنّنا صرنا سجناء من الدرجة العاشرة في وطننا؛ فحكومتنا لا تتعامل معنا حتّى كما تتعامل مع الأجانب. لقد بتنا نتمنّى لو كنّا أجانب كي تكون هناك دولةٌ تطالب بنا، لأنّ بلدنا، للأسف، لا يطالب بنا". تتكرّر في الشهادة مفردات "النقمة" و"الانتقائيّة" و"تسليع العدالة".
ووفق السجين، "تتعامل مؤسّسات الدولة وقضاؤها وإعلامها وأحزابها معنا بوصفنا أقلّ من بشر. لا فرصة ثانية، ولا مراجعة أحكام، ولا تفهّم لسنواتٍ مهدورةٍ بلا محاكمات. يموت رفاقنا واحدًا تلو الآخر، انتحارًا أو إهمالًا، في حين تصمّ الحكومة آذانها". هذا الاحتقان، في رأيه، يجعل من روميّة "قنبلةً على وشك الانفجار".
يُضيف: "كلّه يحوّل سجن رومية، مع الوقت، إلى قنبلةٍ على وشك الانفجار. إنّه موضوعٌ شديدُ الخطورة، وقد حذّرنا منه منذ مدّةٍ ليست بقصيرة، غير أنّ صمت الحكومة اللبنانية ما يزال مُدوّيًا. كانت طلباتهم شديدةَ التحديد: فقد قدّمت "كتلة الاعتدال الوطني" في مجلس النواب مشروعَ قانونٍ في أواخر السنة الماضية، وتحديدًا في شهر كانون الأول/ ديسمبر، لكنّه ـــ ككلّ مرّة ـــ رُفض. وحلّ مشكلة السجون في لبنان بسيطٌ في جوهره، ويتلخّص في تحديد سقفٍ لعقوبة المؤبّد والإعدام، وتقليص "السنة السجنية" ـــ ولو استثنائيًّا ـــ إلى ستة أشهر، وإطلاق سراح من أمضَوا أكثر من عشر سنوات من دون محاكمة ليُتمّوا محاكماتهم من خارج السجن. فهناك انهيارٌ شاملٌ لدى الدولة اللبنانية، وهي عاجزةٌ عن معالجة ملفّ السجون". ويُحذّر: "الوضع بالغُ الخطورة؛ فالسجناء اللبنانيون يشعرون بغضبٍ عارم، وهناك جمرٌ تحت الرماد، وقد يقع الانفجار الكبير في أيّة لحظة."
صبلوح: "العدالة لا تتجزّأ"
يفنّد مدير مركز "سيدار" للدراسات القانونيّة، المحامي محمّد صبلوح، الإشكاليّة على النحو الآتي: "صحيحٌ أنّ ثمّة تفاهماتٍ لبنانيّةً سوريّةً قيد البحث بخصوص الموقوفين السوريّين، لكنّ العمل، للأسف، يجري بالمفرّق، على قاعدةٍ انتقائيّةٍ ظاهرها 'إيجابي' وباطنها ترسيخٌ للتمييز. العدالة لا تجزّأ. لا أستطيع أن أخرج السوريّ وأقول للبنانيّ والفلسطينيّ: انتظروا الاكتظاظ". ويضيف: "راجعت مسؤولين حكوميّين وحذّرت من معالجةٍ مجتزأة تهدّد بانفجارٍ داخل السجون. وقلت: إمّا معالجةٌ شاملةٌ وفق معايير العدالة الانتقاليّة، وإمّا تكرارٌ للنهج الذي راكم المظالم. حتّى اليوم، لا نملك تفاصيل الاتّفاقيّة القضائيّة المتداولة؛ ما يقال في الإعلام يشير إلى 'ترقيعٍ' فرديٍّ، وليس إلى حلٍّ جذريّ".
في شهادته، يذهب صبلوح إلى صلب فساد المنظومة الإجرائيّة: "هناك فبركاتٌ، أخطاءٌ تحقيقية، وثائق اتّصال، ومحكمةٌ عسكريّةٌ صدّقت على تعسّفاتٍ بدلاً من تصويبها. لدينا قاصرٌ لا يعرف تهمته، تؤجّل جلساته ثلاثة أسابيع فثلاثة أسابيع لأنّ السجن عاجزٌ عن سوقه، ثمّ ينتحر فتىً في الرابعة عشرة من عمره. أيُّ دولةٍ هذه التي تعتبر السجون أرقامًا تفاوض بها الأوروبيّين؟". ويختم: "المطلوب إطلاق مسار عدالةٍ انتقاليّةٍ حقيقيّة، معترفٍ بها أمميًّا، تصحّح المظلوميّات وتعالج الاكتظاظ والتوقيف الاحتياطيّ المطوّل والتعذيب والإخفاء، وتضع حدًّا لاستثمار السجون في المناكفات السياسيّة".
إطارٌ قانونيّ: ما الذي يوجبه القانون… لا السياسة؟
أوّلًا: الدستور اللبنانيّ وأصول المحاكمات
تنصّ المادّة الثامنة من الدستور اللبنانيّ على أنّ "الحرّية الشخصيّة مصونةٌ وفي حمى القانون، ولا يمكن أن يقبض على أحدٍ أو يحبس أو يوقف إلّا وفق أحكام القانون". هذا المبدأ لا يكتمل بلا ضماناتٍ إجرائيّة: الحقّ في محاكمةٍ عادلةٍ ضمن مهلةٍ معقولة، ومنع الاعتقال التعسّفي، وحقّ الدّفاع والمساعدة القانونيّة، وحظر التعذيب وسوء المعاملة.
قانون أصول المحاكمات الجزائيّة يحدّد قيودًا على التوقيف الاحتياطيّ، ويشترط المهل وضمانات الدّفاع والعلنيّة، كما يتيح، في حالاتٍ معيّنة، إخلاء السبيل مع كفالة، ويقرّ مبدأ التناسب بين خطورة الجرم ومدّة التوقيف. حين تتحوّل المهل إلى سنواتٍ، تصبح قرينة الظّلم راجحة، ويتحوّل "الاحتياطيّ" إلى عقوبةٍ مسبقةٍ بلا حكم.
ثانيًا: الالتزامات الدوليّة
لبنان طرفٌ في "العهد الدوليّ الخاصّ بالحقوق المدنيّة والسياسيّة" الذي يضمن الحقّ في المحاكمة العادلة وعدم الاحتجاز التعسّفي ("المادّتان 9 و14")، وفي "اتّفاقيّة مناهضة التعذيب" التي تحظر التعذيب حظرًا مطلقًا، وتوجب التحقيق الفعّال في مزاعم التعذيب وتوفير الانتصاف للضحايا. كما تعدّ "قواعد نيلسون مانديلا" (القواعد النموذجيّة الدنيا لمعاملة السجناء) و"قواعد بانكوك" للنساء المحتجزات و"قواعد هافانا" للأحداث، مرجعيّاتٍ معياريّةً ينبغي أن ترشد السياسات العقابيّة. وعلى صعيد حقوق الطفل، تفرض "اتّفاقيّة حقوق الطفل" معاملةً خاصّةً بالأحداث، وقضاءً إصلاحيًّا لا عقابيًّا.
تبعًا لهذه المرجعيّات، فإنّ الاكتظاظ الحادّ، وتأخّر الرعاية الصحيّة، والتأجيلات المتكرّرة، ونقل الطعام البارد البائت في غير أوانه، وتواتر حالات الانتحار من دون تحقيقٍ مستقلٍّ وشفّاف، كلّها مؤشّراتٌ على إخفاقاتٍ ممنهجة تنتهك معها حقوقٌ غير قابلةٍ للتصرّف.
ثالثًا: التسليم والتعاون القضائيّ
تتردّد في الكواليس إشارةٌ إلى اتّفاقيّةٍ قضائيّةٍ قديمة بين بيروت ودمشق تنظّم جوانب من التعاون، غير أنَّ أيَّ إجراءٍ لتسليم موقوفين أو محكومين إلى دولةٍ أخرى يجب أن يخضع لمبدأ "عدم الإعادة القسريّة"، حين تتهدّد الشخص مخاطر تعذيبٍ أو اضطهاد، وبوجهٍ خاصّ في القضايا ذات الطابع السياسيّ أو المصنّفة "إرهابيّة". كما أنّ القاعدة العامّة في القانون الجنائيّ تقضي بأن تنفّذ الدولة التي وقّعت فيها الجريمة العقوبة أو تحاكم المرتكب وفق سلطتها القضائيّة، ما لم تبرم ترتيباتٌ قضائيّةٌ واضحةٌ مستوفيةٌ للضمانات الفرديّة. أيّ معالجةٍ "على المقايضة" تفرّغ هذه الضمانات من معناها.
سياقٌ أطول من الحرب السوريّة
لم يبدأ ملفّ "الموقوفين الإسلاميّين" في الحرب السوريّة. جذوره تعود إلى أحداث الضنّية (1999–2000) حيث اندلعت مواجهاتٌ بين الجيش ومجموعةٍ مسلّحةٍ في جرود الشمال. لاحقًا، شكّل مخيّم نهر البارد (2007) محطّةً داميةً تولّد منها موجات توقيفٍ واسعةٌ شملت لبنانيّين وسوريّين وفلسطينيّين. ومع امتداد الحرب السوريّة إلى طرابلس عبر جولات القتال بين باب التبانة وجبل محسن (حتّى 2014)، اتّسعت دائرة الملاحقات والاعتقالات، لتبلغ ذروتها الرمزيّة في "المبنى باء" من سجن روميّة. كما أدّت أحداث عبرا (2013) إلى محاكماتٍ قاسيةٍ وأحكامٍ مشدّدة بحقّ أحمد الأسير ومجموعاتٍ مناصرة.
في هذا المسار، برزت "وثائق الاتّصال" التي أصدرتها جهاتٌ أمنيّة كآليّةٍ إجرائيّةٍ موضع جدلٍ لسنوات: تعمّم الأسماء على الحواجز، ويوقف أشخاصٌ بناءً على اشتباهاتٍ استخباراتيّة، ثمّ تتكفّل بطء التحقيقات، وتراكم الاتّهامات الفضفاضة، و"شدّة" القضاء العسكريّ، بإيصال مئات القضايا إلى منطقةٍ رماديّةٍ بين التثبّت القانونيّ والاتّهام السياسيّ. هنا تحديدًا يتشكّل إحساس "المظلوميّة المركّبة": توقيفٌ طويلٌ بلا محاكمة، تحقيقاتٌ تشكو التعذيب والإكراه، وتكييفٌ قانونيٌّ متشدّدٌ يتجاهل الفوارق الفرديّة.
أرقامٌ تتحدّث… وغضبٌ يتراكم
تتباين التقديرات لأعداد "الموقوفين الإسلاميّين" اليوم، لكنّ الإشارات المتواترة تتحدّث عن مئاتٍ من اللبنانيّين والفلسطينيّين، إلى جانب كتلةٍ كبيرةٍ من السوريّين داخل السجون اللبنانيّة، على اختلاف التّهم والتصنيفات. جزءٌ غير قليلٍ منهم أمضى سنواتٍ طويلةً بانتظار محاكمة؛ جزءٌ آخر نال أحكامًا قصيرةً نسبيًّا قياسًا بمدّة توقيفه؛ وقلّةٌ صدرت بحقّها أحكامٌ مؤبّدةٌ أو إعدام. في المقابل، تتحدّث مصادر عن وجود آلاف الموقوفين السوريّين في قضايا متّصلةٍ بالتسلّل والإقامة والقتال والارتباط بتنظيمات، منهم من يصنّفون في خانة "الإرهاب" وفق توصيفات القضاء العسكريّ.
هذه الفوارق الرقميّة ليست بذاتها المشكلة؛ المشكلة أنّها تتغذّى من انهيارٍ إداريٍّ وماليٍّ وقضائيٍّ يضرب الدولة اللبنانيّة منذ سنوات: تقليصٌ في الموازنات، تعطّلٌ جزئيٌّ للمرفق القضائيّ، ضعف قدرات النقل والحراسة، شللٌ في الطّبابة والاستشفاء، وفراغٌ سياسيٌّ يجمّد المبادرات التشريعيّة. عند هذا التقاطع، تصبح "المعالجة الانتقائيّة" شرارةً فوق برميل بارود.
يقول صبلوح: "في أيَّة دولةٍ تدخل عهدًا جديدًا، تطلق عمليّة عدالةٍ انتقاليّة". لبنان عاش تحوّلاتٍ كبرى منذ 2019: انتفاضةٌ شعبيّة، انهيارٌ اقتصاديّ، تفجّر فضائح حوكمة، وضغطٌ غير مسبوقٍ على القضاء. كان يمكن لهذه المرحلة أن تستثمر لإطلاق مسارٍ وطنيٍّ شاملٍ لتصويب العدالة الجنائيّة: مراجعة أحكامٍ قاسية، تدقيقٍ مستقلٍّ في ادّعاءات التعذيب، ضبط "وثائق الاتّصال" وربطها برقابةٍ قضائيّةٍ فعّالة، تقليص التوقيف الاحتياطيّ، اعتماد بدائل للعقوبة السالبة للحرّيّة في الجرائم غير الخطرة، تشبيكٍ طبّيٍّ وقضائيٍّ للملفّ الصحيّ في السجون، وتفعيل آليّات المحاكمة عن بعد بضوابط صارمةٍ تضمن علنيّة وشفافيّة الإجراءات. لكنّ الذي حدث، وفق شهادات محامين وناشطين حقوقيّين، هو العكس: "عملٌ بالمفرّق"، ترقيعٌ ظرفيٌّ محكومٌ بالإكراهات السياسيّة، وتغليبٌ لمنطق "التبريد الأمنيّ" على حساب بناء الثقة مع فئاتٍ واسعةٍ تشعر أنّه جرت "شيطنتُها" مذ ختمت ملفاتها بخاتم الإرهاب.
المعيار الوحيد: إنسانيّة العدالة
لا يطلب السجناء اللبنانيّون والفلسطينيّون امتيازًا؛ بل مساواةً في المعاملة وفق معيار القانون. حين يقال إنّ ثمّة توجّهًا "لاستثناء" فئاتٍ بذريعة "قتل عناصر الجيش" مثلًا، يكون السؤال القانونيّ: أين الدليل؟ هل ثبتت المسؤوليّة الجنائيّة الفرديّة بما لا يدع مجالًا للشكّ، أم أنّ الملفّات مثقلةٌ باعترافاتٍ مشوبةٍ بالإكراه وبأدلّةٍ ظرفيّة؟ "أرني من هم، وقدّم الأدلّة لا الفبركات"، يقول صبلوح. هنا يتقدّم مبدأٌ أساسيٌّ في العدالة الجنائيّة: "الشخصيّة" و"الفرديّة" و"المشروعيّة". لا إدانة بلا محاكمةٍ عادلة، ولا عقوبة بلا يقينٍ قضائيّ، ولا تمييز بين موقوفٍ وآخر على أساس الانتماء أو الجنسيّة أو التصنيف السياسيّ.
ويلخّص سجناء ونوّابٌ ومحامون "خريطة طريق" يمكن أن تكون منقذةً:
تحديد سقفٍ لعقوبة المؤبّد والإعدام عبر تحويل المؤبّد إلى مدّةٍ محدّدةٍ قابلةٍ للمراجعة، ووقف تنفيذ الإعدام عمليًّا وقانونيًّا.
تقليص "السنة السجنيّة" بصورةٍ استثنائيّة إلى ستّة أشهرٍ لفترةٍ محدودة في إطار خطّة طوارئ إنسانيّة لمعالجة الاكتظاظ، مع مراعاة معايير الخطورة وتقييم المخاطر الفرديّ.
إخلاء سبيل من أمضوا أكثر من عشر سنواتٍ من دون محاكمةٍ لاستكمال قضاياهم وهم طلقاء بضماناتٍ إجرائيّة (كفالة، منع سفر، مراقبةٌ قضائيّة).
مراجعةٌ شاملةٌ لملفّ "وثائق الاتّصال" بإشرافٍ قضائيٍّ مستقلّ، وإسقاط الملاحقات غير المستندة إلى أدلّةٍ قانونيّةٍ كافية.
تفعيلٌ دائمٌ للمحاكمة عن بعد بوصفها أداةً لوجستيّةً، لا بوصفها بديلاً عن علنيّة وشفافيّة المحاكمة، مع جداول زمنيّةٍ ملزمةٍ لدوائر الجنايات.
إنشاء آليّةٍ وطنيّةٍ مستقلّةٍ للتحقيق في مزاعم التعذيب وسوء المعاملة داخل أماكن الاحتجاز، وتفعيل "الآليّة الوقائيّة الوطنيّة" المنصوص عليها في البروتوكول الاختياريّ لاتّفاقيّة مناهضة التعذيب.
خطّة طوارئ للصحة والسكن والغذاء في السجون، تضمن وصول الطعام في مواعيده بجودةٍ مقبولة، وتأمين النقل الطبّيّ العاجل، وتعاقدات مستشفياتٍ ملزمة.
مسار "عدالةٍ انتقاليّة" محدود الغاية زمنيًّا وقانونيًّا لمعالجة التراكم التاريخيّ للأخطاء القضائيّة والأمنيّة بين 1999 و2020، بآليّات مراجعةٍ وإعادة محاكمةٍ وتعويض.
اختبارٌ أخلاقيٌّ للدولة
تتبدّى الخلاصة في سؤالٍ بسيط: هل تستطيع الدولة اللبنانيّة أن تقول لسجنائها اللبنانيّين والفلسطينيّين إنّهم ليسوا "أرقامًا" على لوائح تفاوض، وإنّ حقوقهم تساوي حقوق أيّ سجينٍ سوريٍّ أو غيره؟ وإذا قالت ذلك، فهل تثبت صدقيّتها بخطّةٍ زمنيّةٍ معلنة، لا بوعودٍ شفويّة؟ يقول أحد السجناء "للمدن": "كلّ أسبوعٍ يموت شخص، انتحارًا أو إهمالًا، ولا أحد ينتبه. حذّرنا مرارًا من انفجارٍ داخل السجون. الصوت وصل. الصمت مدوٍّ".
اختزلت مأساة السجون في لبنان بالمبنى الشهير في روميّة. لكنّ تحويل الرمز إلى قدرٍ أبديٍّ يريح السياسيّين: يتحدّثون عن "خصوصيّة" المبنى، كأنّ معالجة "الخصوصيّة" تكفي لإغلاق الملفّ. الحقيقة أنّ "ب" هو مرآةٌ لنظام عدالةٍ مأزوم، لا استثناءٌ فيه. إنقاذه يمرّ بإرادةٍ سياسيّةٍ تعترف بأنّ السجون ليست "أرقامًا للتفاوض" ولا "ملفّاتٍ للاستثمار" ولا "قنابل للابتزاز". هي فضاء اختبارٍ لكرامة الإنسان ولجدّية الدولة. وإن كان لا أحد ينازع سجينًا سوريًّا فرحته إذا استعاد حرّيته وفق القانون والضمانات. وهذا "فرحٌ مستحقّ". لكنّ "الخذلان العميق" الذي يشعر به السجناء اللبنانيّون والفلسطينيّون ليس دعايةً ولا ابتزازًا؛ إنّه خلاصة ربع قرنٍ من التراكمات: من الضنّية إلى نهر البارد، ومن جولات طرابلس إلى عبرا، ومن "وثائق الاتّصال" إلى محاضر تحقيقٍ تشكو التعذيب، ومن قاعات محاكماتٍ تتأجّل إلى غرفٍ رطبةٍ تصلها وجباتٌ باردةٌ بعد المغيب
المصدر المدن